صنع الله إبراهيم: أدب المقاومة وذاكرة الرفض
روايات صنع الله إبراهيم تستعيد الذاكرة الاستعمارية لتكشف استمرار أنماط السيطرة، وتربط بين التجربة المصرية والعربية وبين تجارب شعوب أخرى في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
-
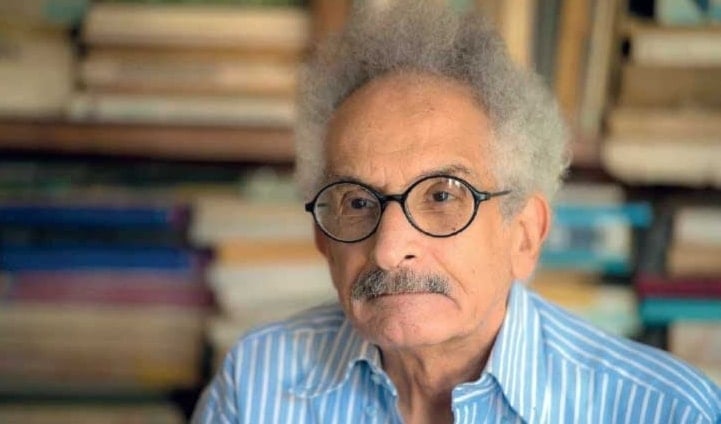
صنع الله إبراهيم والأدب المقاوم (أرشيف).
صنع الله إبراهيم واحد من أكثر الأصوات تفرّداً في المشهد الأدبي العربي المعاصر، كاتب لا يمكن اختزاله في جنس أدبي واحد أو تيار بعينه، بل هو، قبل كل شيء، ضمير يقظ وذاكرة مقاومة. منذ روايته الأولى اللجنة وحتى أعماله الأخيرة، ظل يكتب بنبرة تمزج بين السرد الوثائقي واللغة الفنية المكثفة، ليصوغ نصوصاً تُشبه بيانات احتجاج أدبي ضد الاستبداد المحلي والهيمنة العالمية.
الخصائص الفنية لنتاجه
يمتاز أسلوب صنع الله إبراهيم بصرامة بنائية متعمدة، فهو يميل إلى تقنيات “التوثيق الروائي” حيث تتشابك المادة الأرشيفية – مقتطفات صحافية، بيانات سياسية، إحصاءات – مع السرد الروائي. هذه البنية الهجينة تخلق نصوصاً تُربك الفصل التقليدي بين “الخيالي” و”الواقعي”، وتجعل القارئ شاهداً وشريكاً في المحاكمة الفكرية التي يجريها النص.
كما تتسم لغته بالاقتصاد الحاد، جمل قصيرة ومباشرة، لكن كثافتها الدلالية تجعل من كل عبارة حجراً في بناء موقف. ومن سماته أيضاً تعدّد الأصوات، حيث يفسح المجال لتداخل وجهات النظر، ما يمنح النص بعداً جدلياً وتاريخياً.
الأثر الاجتماعي
ارتبطت روايات صنع الله إبراهيم بوعي اجتماعي حاد. في ذات، مثلاً، يلتقط التحولات الاقتصادية والاجتماعية في مصر عبر حياة موظفة بسيطة، ليكشف كيف تنعكس السياسات النيوليبرالية على تفاصيل الحياة اليومية. وفي وردة، يستحضر تجربة الثورة العمانية في ظفار، مقدماً نموذجاً للأدب الذي يربط المحلي بالعربي، والشخصي بالجمعي.
هذه النصوص شكّلت عند قرائها جسراً لفهم التاريخ الاجتماعي والسياسي، وأثّرت في جيل من المثقفين الذين وجدوا في كتاباته أداة للقراءة النقدية للمجتمع.
الحضور السياسي
الحس السياسي ليس عارضاً في أعماله، بل هو جزء من بنيتها العميقة. صنع الله إبراهيم، الذي سُجن سنوات في الحقبة الناصرية بسبب انتمائه اليساري، ظل يكتب بروح المعارض الدائم، رافضاً التواطؤ مع السلطة. رفضه لجائزة الدولة التقديرية عام 2003 كان فعلاً أدبياً بقدر ما هو موقف سياسي، إذ حوّل المنصة إلى منبر لانتقاد سياسات الحكومة المصرية آنذاك.
في رواياته، السياسة ليست مجرد خلفية، بل هي محرك للأحداث والشخصيات، وعنصر يفرض على القارئ التفكير في معنى السلطة والحرية والعدالة.
الأبعاد الإنسانية
على الرغم من الطابع السياسي الغالب، فإن أعمال صنع الله إبراهيم تنبض بعمق إنساني. شخصياته ليست رموزاً جامدة، بل كائنات حية، تتصارع بين أحلامها وهزائمها، بين رغبتها في التغيير واستسلامها للقهر اليومي. هذا البعد الإنساني يذكّر بأن المقاومة، في نظره، ليست فقط مواجهة عسكرية أو خطابية، بل أيضاً فعل صمود في تفاصيل الحياة.
الموقف من الكولونيالية والاحتلال
يندرج مشروعه الإبداعي في سياق مقاومة الكولونيالية بأشكالها القديمة والجديدة. في نصوصه، نقد صارم للهيمنة الغربية، سواء عبر الاحتلال المباشر أم عبر أدواته الاقتصادية والثقافية.
رواياته تستعيد الذاكرة الاستعمارية لتكشف استمرار أنماط السيطرة، وتربط بين التجربة المصرية والعربية وبين تجارب شعوب أخرى في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
فلسطين والصراع ضد الصهيونية
فلسطين في أدب صنع الله إبراهيم ليست قضية “خارجية” أو “متضامنة عن بُعد”، بل جزء من وعيه السياسي والأدبي. في أكثر من عمل، تظهر الإشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي بوصفه الامتداد الأكثر فجاجة للمشروع الاستعماري في المنطقة. نقده للصهيونية يتجاوز المستوى الخطابي إلى تفكيك بنيتها الإيديولوجية، وربطها بمنظومة السيطرة الإمبريالية.
بهذا، تصبح الكتابة عن فلسطين امتداداً لمشروعه الأوسع في الدفاع عن الحرية والسيادة وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
أدب يقاوم النسيان
صنع الله إبراهيم ليس مجرد روائي بارز، بل هو شاهد على زمنه، وفاعل في تشكيل الوعي الجمعي. أدبه مشروع مقاومة متكاملة: مقاومة الاستبداد في الداخل، والهيمنة في الخارج، وطمس الذاكرة، والاستسلام لليأس.
في زمن تتسارع فيه محاولات طمس الحقائق وتزييف الوعي، تظل نصوصه أرشيفاً مفتوحاً للمقاومة، وأدباً يقاوم النسيان.
روائي ضد التيار
ينتمي صنع الله إبراهيم إلى سلالة الكتاب الذين لا يرون الأدب نشاطاً جماليًا منفصلاً عن شروطه التاريخية، بل جزءًا من معركة الوعي. تجربته منذ تلك الرائحة (1966) تكشف عن مشروع أدبي متصل، يسعى إلى هدم وهم الحياد الأدبي، ويصر على أن الكتابة فعل سياسي، حتى في أكثر أشكالها تجريبية.
هذا الموقف يجعله قريبًا في الروح من كتّاب يساريين عالميين مثل أليخاندرو زامبرا في أمريكا اللاتينية أو ألكسندر سولجنتسين في فضح قمع السلطة، وإن اختلفت الأنساق السياسية والموضوعات.
البنية السردية: بين الوثيقة والرواية
يعتمد صنع الله إبراهيم على ما يمكن تسميته “البنية التوثيقية المفتوحة” حيث تتجاور الوثائق الصحافية، الإحصاءات الرسمية، والمواد الأرشيفية مع صوت الراوي، من
دون محاولة إخفاء التناقضات بينها.
في اللجنة، يتحول التحقيق الإداري إلى متاهة بيروقراطية تشبه Kafka لكن بلغة مصرية جافة ومباشرة، تكشف عبثية السلطة. هنا تتجلى تقنية “توليد المعنى من التكرار البيروقراطي” وهو ما يوازي أسلوب بريخت في المسرح الملحمي الذي يوقف التدفق السردي لإجبار المتلقي على التفكير بدل الانغماس.
الشخصيات: نماذج اجتماعية لا أبطال كلاسيكيين
شخصياته أقرب إلى “أنماط” تحمل دلالات اجتماعية – مثل بطلة ذات التي تجسد تحولات مصر في عصر الانفتاح – لكنها في الوقت نفسه فردية بما يكفي لتكون حيّة أمام القارئ. هذا المزج بين الفردي والنمطي يذكّر بتقنيات الواقعية الاشتراكية عند كتّاب مثل ماكسيم غوركي، لكن مع تفادي المباشرة التعليمية لصالح السخرية والتهكم.
التاريخ كحاضر دائم
صنع الله إبراهيم يتعامل مع التاريخ لا كخلفية جامدة، بل كفاعل يهيمن على الحاضر. في وردة، يتم سرد أحداث الثورة العُمانية عبر حوار بين الماضي والحاضر، ما يعكس وعيًا بجدلية الاستعمار والمقاومة. هذه المعالجة للتاريخ تقترب من نهج غابرييل غارسيا ماركيز في مئة عام من العزلة، حيث تتشابك الأزمنة لإظهار استمرارية البنية القمعية.
اقتصاد التعبير وتكثيف الدلالة
أسلوبه اللغوي يرفض الزخرفة، ويعتمد على جمل قصيرة وباردة، أشبه بتقارير سياسية أو مواد أرشيفية. هذا الاقتصاد اللغوي يتوافق مع مقاصده السياسية: فضح الواقع من دون تزييفه بجماليات مفرطة. ويمكن هنا مقارنته بجورج أورويل، الذي جعل من وضوح اللغة أداة لكشف السلطة.
فلسطين والصراع ضد الصهيونية
القضية الفلسطينية ليست مجرد ثيمة تضامنية، بل هي جزء من البنية السردية في أعماله. في أكثر من موضع، يظهر الاحتلال الإسرائيلي كأقصى أشكال الكولونيالية العنيفة، مرتبطًا بالمصالح الإمبريالية العالمية. هذه المعالجة تجعل نصوصه أقرب إلى روايات الطاهر وطار أو إلياس خوري، التي تمزج بين السرد الفني والتحريض السياسي.
المقارنة مع الأدب اليساري العالمي
يمكن وضع صنع الله إبراهيم في حوار مع:
• إدواردو غاليانو (شرايين أمريكا اللاتينية المفتوحة) في المزج بين السرد التاريخي والوثيقة لكشف البنية الاستعمارية.
• جون دوس باسوس في ثلاثيته الولايات المتحدة الأمريكية، حيث التداخل بين الوثائق والخيال.
• دوريس ليسينغ في ربط التجربة الشخصية بالبنية الإمبريالية.
الأبعاد الإنسانية: من السياسة إلى اليومي
على الرغم من مركزية السياسة، لا يغيب عن نصوصه الاهتمام بما هو شخصي: الحب، الفقد، الإحباط، الأمل. هذه التفاصيل تمنح أعماله بعدًا إنسانيًا يذكّر بأن النضال ليس خطابات كبرى فقط، بل أيضًا مقاومة صغيرة في الحياة اليومية.
مشروع أدبي للمقاومة الطويلة
صنع الله إبراهيم ليس كاتبًا يلهث وراء اللحظة، بل بنى مشروعًا أدبيًا متماسكًا على مدى عقود، يربط المحلي بالعالمي، والسياسي بالإنساني، والتوثيق بالفن. إن مقارنة تجربته بمسارات الأدب اليساري العالمي تكشف عن فرادته: فهو لم يكتفِ باستلهام تقاليد المقاومة الأدبية، بل أعاد صياغتها في سياق عربي ومصري، لتصبح نصوصه أرشيفًا أدبيًا للوعي المقاوم.
يمكن قراءة مسيرة صنع الله إبراهيم الإبداعية كسردية متصلة، تتحرك عبر مراحل متباينة في الشكل والمضمون، لكنها جميعًا تحمل بصمة واحدة: الانحياز للمقاومة والرفض، وتحويل الأدب إلى أداة كشف وتعرية للسلطة.
رحلته الإبداعية
بدأت رحلته عام 1966 بـ “تلك الرائحة”، النص القصير الذي مثّل ولادة صوته الخاص. من خلال تجربة السجن السياسي وما تلاها، رسم عالماً بارداً وواقعياً بلغة مقتضبة وجمل قصيرة، متخليًا عن الحبكة التقليدية لصالح المونولوج الداخلي. كان ذلك إعلاناً مبكراً عن مشروع نقدي يواجه القمع من داخل التجربة اليسارية نفسها، كاشفًا أثره العميق على الفرد.
في “اللجنة” (1981)، يواصل تمرّده الفني والفكري عبر شخصية مجهولة تدخل في مواجهة مع بيروقراطية غامضة، في حبكة تتحول إلى مرآة لعبثية السلطة. مزج الفانتازيا البيروقراطية بالنقد السياسي، مستلهمًا تقنيات كافكا وبريخت، ليكشف آليات السيطرة الإعلامية والإدارية التي تصنع الشرعية الزائفة.
مع “ذات” (1992)، وسّع صنع الله إبراهيم عدسته السردية لتشمل التاريخ الاجتماعي لمصر عبر العقود، متتبعًا حياة موظفة عادية، ومقحماً بين الفصول مقاطع وثائقية من الصحافة الرسمية. هنا يتقاطع الخاص والعام، ويتحول التكرار إلى أداة نقدية تكشف سياسات الانفتاح والفساد وانهيار الطبقة الوسطى.
في “برلين 69” (1994)، يخوض تجربة شبه يومية في ألمانيا الشرقية، مقدّمًا شهادة شخصية تتقاطع مع سياقات الحرب الباردة. النص هنا مزيج من الملاحظة الحياتية المباشرة والتحليل الثقافي، يكشف التناقضات بين الاشتراكية الواقعية والنموذج الرأسمالي.
جاءت “وردة” (2000) لتعيد إلى السرد العربي لحظة منسية من التاريخ الثوري العربي: الثورة العُمانية في ظفار. عبر بحث صحافي وتنقل بين أزمنة متعددة وأصوات متداخلة، قدّم صنع الله إبراهيم نصًا يوثّق التضامن العربي الثوري، ويربط النضال المحلي بالحركات التحررية العالمية.
في “أمريكانلي” (2003)، واجه الكاتب الهيمنة الثقافية والسياسية الأميركية من قلب الولايات المتحدة، عبر يوميات مثقف مصري يراقب تناقضات “الديمقراطية” الأميركية. الأسلوب الواقعي المباشر والملاحظات الإثنوغرافية عزّزا الطابع النقدي للرواية، لتكون قراءة في الاستعمار الثقافي المعاصر.
ثم جاءت “شرف” (2005) لتفتح أبواب السجون المصرية على مصاريعها. من خلال قصة سجين تورط في قضايا شرف وفساد، استخدم السرد متعدد المستويات، وأدرج تقارير وإحصاءات رسمية، كاشفًا المنظومة القضائية والسجنية بوصفها مرآة للفساد السياسي والاقتصادي.
في “العمامة والقبعة” (2007)، عاد إلى القرن التاسع عشر ليقرأ تاريخ مصر في زمن التحولات بين العثمانيين والبريطانيين. مزج الوثائق التاريخية بالسرد الروائي، مستخدمًا لغة تمزج بين المعاصرة والتراثية، ليحلل جذور البنية الكولونيالية وبدايات النهضة.
وأخيرًا، مع “التلصص” (2011)، اتخذ منظور طفل يراقب العالم من نافذة بيته. اللغة هنا بسيطة لكن مشحونة بالإيحاء، تكشف تناقضات المجتمع وبناه المحافظة، وتعيد التذكير بأن النقد يمكن أن ينبع حتى من أكثر المواقف براءة.
تُظهر هذه المسيرة ثلاث مراحل واضحة:
• المرحلة الأولى (1966–1981): تجريب شكلي صارم، وكسر للتقاليد السردية، وحضور مباشر لتجربة السجن والقمع.
• المرحلة الوسطى (1992–2003): توسّع نحو التاريخ الاجتماعي والسياسي، وإدماج الوثيقة مع الخيال، وتحويل الرواية إلى أرشيف حي للتاريخ اليومي.
• المرحلة المتأخرة (2005–2011): الجمع بين الرواية الوثائقية والتاريخية، والانفتاح على قضايا عربية وعالمية، مع الإبقاء على حدّة الموقف النقدي.
هكذا، تكتمل صورة صنع الله إبراهيم ككاتب مشاغب أدبيًا، ملتزم سياسيًا، يكتب ضد النسيان، ويجعل من الرواية مساحة مفتوحة للمساءلة التاريخية والإنسانية.
















